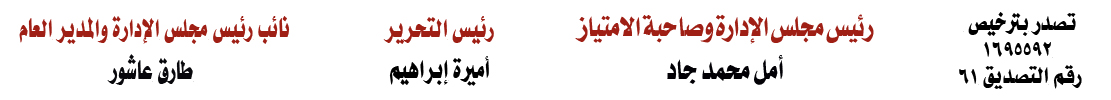الخبير التربوي الدكتور ناصر الجندي يكتب “أسرى الامتحانات أم روّاد المعرفة؟ رحلة داخل دهاليز التعلم ومصيدة التقييم”
بقلم الخبير التربوي الدكتور ناصر الجندي
حين يصبح الامتحان غاية والعلم وسيلة
في صباح بارد، يقف طالب في الصف الثالث الثانوي أمام باب المدرسة، يضم دفتره إلى صدره، ويردد في سره آياتٍ ودعوات. ليس على موعد مع اختبار للذات، بل مع “معركة درجات”. تتسارع نبضاته، لا لأن المعرفة تناديه، بل لأن الامتحان يطارده. المشهد مألوف حد الألم في مختلف أرجاء العالم.
لكن ماذا لو توقفنا لحظة وسألنا:
هل خُلق التعلم من أجل الامتحان؟ أم وُضع الامتحان ليخدم رحلة التعلم؟
هذا المقال ليس مجرد محاولة للإجابة عن هذا السؤال، بل هو غوصٌ عميق في علاقة ملتبسة، تقف على الحافة بين التحفيز والإخضاع، بين بناء الإنسان وقياسه.
الامتحان… من أداة تقييم إلى فزاعة عقلية
يُقال إن الامتحانات مثل أشعة الأشعة السينية، تكشف ما بداخل العقل. لكنها كثيرًا ما تتحول إلى قيدٍ على النفس. نشأت الامتحانات في بداياتها لتكون وسيلة لتقدير مدى استيعاب المتعلم للمادة، لكنها تطورت تدريجيًا لتصبح حكمًا نهائيًا على قيمة الإنسان في المجتمع. إنها “لحظة الحكم” التي قد تُحدد المستقبل المهني والاجتماعي.
يقول “ألفين توفلر” (Alvin Toffler):
“أمية القرن الحادي والعشرين ليست في عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل في عدم القدرة على التعلم وإلغاء ما تم تعلمه وإعادة التعلم”
(Toffler, 1970).
لكن هل تتيح لنا الامتحانات هذا النوع من التعلم؟ أو هل تمنحنا حق الخطأ؟ الحق في المحاولة والتكرار؟ الجواب غالبًا: لا.
الامتحان كما يُطبق الآن في كثير من الأنظمة التعليمية أشبه بـ”زرع الذاكرة المؤقتة”، يُنزع بعد انتهاء الجلسة. يركّز على الحفظ والتكرار، ويعاقب على الإبداع والتساؤل. الطالب الذي يتساءل، يُعد مشاغبًا. والذي يطلب شرحًا مختلفًا، يُقال له “احفظ كما في الكتاب”.
التعلم… حين يكون شغفًا لا فرضًا
في المقابل، يبدو التعلم ككائن حيّ، يزدهر في بيئة الأسئلة والانبهار، لا في قاعة الصمت والإملاءات. يقول “جون هولت” (John Holt):
“الأطفال لا يفقدون حب التعلم، بل يفقدون حب المدرسة”
(Holt, 1982).
التعلم الحقيقي لا يحدث تحت الضغط، بل تحت الإلهام. إنه عملية عضوية، تستدعي فضولًا دائمًا، وتمنح حرية التفكير. ولا يخفى أن بعض أعظم العقول في التاريخ—مثل أينشتاين، ستيف جوبز، ومالكوم إكس—تعلموا خارج سياق الامتحان، وتجاوزوا النظم التقليدية.
في فلسفة “جون ديوي” (Dewey, 1938)، لا يمكن فصل التعلم عن التجربة. الطفل الذي يصنع نموذجًا لمحرّك كهربائي، أو يرسم خريطة لمدينته، يتعلم أكثر من مئة سؤال موضوعي. المعرفة التي تُبنى ذاتيًا تبقى، أما تلك المفروضة فتتبخر.

هل يمكن أن يصبح الامتحان صديقًا؟
قد يبدو السؤال مستفزًا: هل يمكن للامتحان أن يصبح رفيقًا للتعلم؟ الحقيقة أن الإجابة ليست بالنفي المطلق. المشكلة ليست في فكرة التقييم، بل في كيفيته وتوقيته وغايته.
الامتحانات التكوينية (Formative Assessment)، على سبيل المثال، تتيح للمعلم والطالب فرصة تحسين الأداء تدريجيًا، عبر ملاحظات بنّاءة بدلًا من درجات نهائية.
تقول “ديلان ويليام”:
“الاختبار التكويني ليس اختبارًا للطالب، بل اختبار للتعليم ذاته.”
(Wiliam, 2011)
عندما يتحول الامتحان إلى تجربة تعلم، حين يُسمح للطالب أن يخطئ ويعيد، ويشعر أن الخطأ فرصة، لا فشلًا، فإنه يبدأ في النمو الفكري والنفسي.
بل ويمكن أن تصبح بعض أدوات التقييم متعة حقيقية، حين تُبنى على المشروعات، أو حل المشكلات، أو حتى الألعاب التعليمية القائمة على التفكير التحليلي والابتكار.
هل نحتاج إلى “ثورة تعلم”؟
العالم يتغير بسرعة هائلة. الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والتعليم عبر الإنترنت يعيدون تشكيل مفاهيم المعرفة والمهارات. السؤال إذن:
هل ما زالت الامتحانات التقليدية صالحة لقياس الاستعداد لعالم غير تقليدي؟
يرى “كين روبنسون” أن التعليم الحديث يعاني من “فقر خيالي”، حيث تُقتل الأحلام في قاعة الامتحانات، وتُكافأ الإجابات النموذجية على حساب الأفكار الأصلية.
“المدرسة كما نعرفها تُعد الطلبة لعالمٍ لم يعد موجودًا”
(Robinson, 2015)
الثورة المطلوبة ليست فقط في المحتوى، بل في طريقة التقييم. نحن بحاجة إلى تعليم يزرع مهارات التفكير، لا مجرد استرجاع المعلومات. نحتاج إلى تقييم يقيس الإبداع، والمرونة، والعمل الجماعي، والقدرة على التعلّم الذاتي.
حين يقود التعلم الطريق
في نهاية المطاف، التعليم ليس سباقًا، بل رحلة. والامتحان ليس نهاية الطريق، بل مجرد لافتة على جانبه.
إذا أردنا جيلًا يفكر ويحلل ويخترع، فعلينا أن نعيد كتابة علاقة التعليم بالامتحان. لا نُقصي التقييم، بل نعيد إليه معناه الأصلي: أن يكون أداة لاكتشاف الذات، لا للحكم عليها.
فلنعلّم أبناءنا كيف يتعلمون، لا كيف يجيبون فقط. دعونا نمنحهم الشغف، لا الخوف. ولا ننسى أن العقل مثل العضلة، لا ينمو بالضغط بل بالتمرين.
“إذا لم يشعر الطالب بالحماسة وهو يتعلم، فثمة خطأ في طريقة التدريس، لا في الطالب”
(Hattie, 2009)
المراجع
1. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.
2. Goodwin, B., & Hein, G. E. (1995). The Constructivist Museum. Journal of Education in Museums, 16(1), 21-23.
3. Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge.
4. Holt, J. (1982). How Children Fail. Perseus Books.
5. Robinson, K. (2015). Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. Viking.
6. Toffler, A. (1970). Future Shock. Random House.
7. Wiliam, D. (2011). Embedded Formative Assessment. Solution Tree Press.