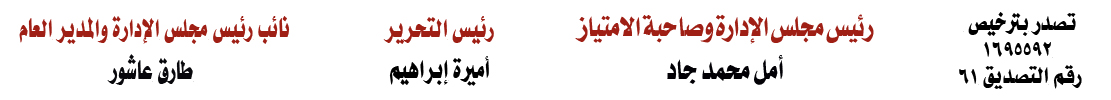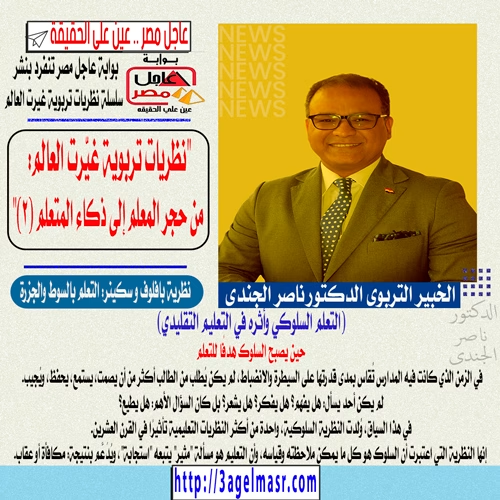
الدكتور ناصر الجندي يكتب”نظريات تربوية غيّرت العالم: من حجر المعلم إلى ذكاء المتعلم” (2)
نظرية بافلوف وسكينر: التعلم بالسوط والجزرة (التعلم السلوكي وأثره في التعليم التقليدي)
بقلم الخبير التربوي الدكتور ناصر الجندي
حين يصبح السلوك هدفًا للتعلم
في الزمن الذي كانت فيه المدارس تُقاس بمدى قدرتها على السيطرة والانضباط، لم يكن يُطلب من الطالب أكثر من أن يصمت، يستمع، يحفظ، ويُجيب. لم يكن أحد يسأل: هل يفهم؟ هل يفكر؟ هل يشعر؟ بل كان السؤال الأهم: هل يطيع؟
في هذا السياق، وُلدت النظرية السلوكية، واحدة من أكثر النظريات التعليمية تأثيرًا في القرن العشرين. إنها النظرية التي اعتبرت أن السلوك هو كل ما يمكن ملاحظته وقياسه، وأن التعليم هو مسألة “مثير” يتبعه “استجابة”، ويُدَعَّم بنتيجة: مكافأة أو عقاب.
النظرية التي لا تؤمن بوجود عقلٍ باطن، ولا دوافع غامضة، ولا أحلام ولا مشاعر. فقط: السلوك الظاهر. وكأن الإنسان آلة تتفاعل مع بيئتها من دون عمق داخلي.
من بافلوف إلى سكينر: هكذا بدأ كل شيء
بدأت القصة في روسيا، مع عالم الفسيولوجيا الشهير إيفان بافلوف (Ivan Pavlov)، الذي كان يدرس الهضم لدى الكلاب، لا التعلم. وخلال تجاربه لاحظ أن الكلب يبدأ بإفراز اللعاب لمجرد سماع خطوات المُجرّب، أو صوت الجرس، حتى قبل ظهور الطعام.
هنا وُلد مفهوم “الاشتراط الكلاسيكي” (Classical Conditioning)، وهو أن مثيرًا محايدًا (مثل صوت الجرس) إذا اقترن عدة مرات بمثير غير شرطي (الطعام)، يتحول إلى مثير شرطي قادر على إثارة نفس الاستجابة (اللعاب).
“التعلم هو تكوين ارتباط بين مثيرين خارجيين.” (Pavlov, 1927)
ثم جاء العالم الأمريكي بورهوس فريدريك سكينر (B.F. Skinner)، فطوّر النظرية السلوكية وأضاف لها بعدًا جديدًا أكثر تأثيرًا: الاشتراط الإجرائي (Operant Conditioning).
في تجاربه الشهيرة على الفئران والحمام، صمم سكينر “صندوق سكينر”، حيث يتلقى الحيوان طعامًا عند ضغطه على زر معين. وإذا قوبل السلوك بنتيجة إيجابية (تعزيز)، فإنه يتكرّر. أما إذا قوبل بعقوبة أو نتيجة سلبية، فإنه يختفي تدريجيًا.
“السلوك تحدده نتائجه” (Skinner, 1953)
المفاهيم الجوهرية للنظرية السلوكية
1. السلوك قابل للملاحظة والقياس فقط.
2. البيئة الخارجية هي المتحكم الرئيسي في السلوك.
3. العقل البشري صندوق أسود لا يمكن دراسته.
4. التعلم يحدث من خلال التكرار والتعزيز والعقاب.
5. المعلم هو المسيطر والموجّه، والمتعلم مستجيب سلبي.
في الصفوف الدراسية: تطبيقات السلوكية بالتفصيل
اعتمدت المدارس في القرن العشرين – ولا تزال في بعضها حتى اليوم – على مبادئ النظرية السلوكية:
المكافآت: إعطاء درجات، نجوم ذهبية، أو شهادات للطلاب المتفوقين أو المنضبطين.
العقوبات: الحرمان من الاستراحة، الخصم من الدرجات، الإنذارات.
التمارين التكرارية: تكرار نفس المسائل الحسابية أو الإملائية لتعزيز التعلم.
البرمجيات التعليمية التقليدية: التي تعتمد على أسلوب “السؤال – الإجابة الصحيحة – الانتقال للمرحلة التالية”.
هذه البيئة تشبه إلى حدٍّ كبير ما وصفه سكينر نفسه:
“التعلم ليس عملية داخلية، بل سلوك يتم تشكيله تدريجيًا عبر التعزيز المنظم.” (Skinner, 1968)

نقد النظرية: روبوتات تعليمية؟
رغم قوة النظرية السلوكية وانتشارها، إلا أنها لم تسلم من نقد واسع:
1. تُهمَّش دور التفكير والمشاعر والدوافع الذاتية: فالتعلم ليس فقط استجابة، بل فهم وتأمل.
2. تجعل الطالب مفعولًا به لا فاعلًا: ينتظر دائمًا توجيهًا خارجيًا.
3. تعزز الطاعة بدل الإبداع: لأن الهدف يصبح إرضاء المعلم أو الحصول على المكافأة.
4. تحفّز على التعلم السطحي لا العميق: فالعقل لا يُبنى بالتكرار فقط.
قال عالم النفس التربوي كارل روجرز (Carl Rogers):
“السلوكية تشرح كيف يُروّض الإنسان، لكنها لا تشرح كيف ينمو.”
هل ما زالت السلوكية حية؟ تطبيقات معاصرة
رغم ظهور نظريات معرفية وبنائية واجتماعية، إلا أن السلوكية لم تختفِ، بل تطورت وأُعيد توظيفها:
تعديل السلوك: في حالات صعوبات التعلم أو اضطراب فرط الحركة.
برمجة الألعاب التعليمية (Gamification): حيث يحصل المتعلم على نقاط أو مستويات.
إدارة الصف: عبر أنظمة التعزيز الفوري.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليمية: التي تعتمد على تغذية راجعة فورية ومحفزات رقمية.
من العصا والجزرة إلى تعليم ينمي الإنسان
علمتنا النظرية السلوكية الكثير عن السلوك البشري، لكنها ليست نهاية الطريق. نحن بحاجة إلى تعليم يدمج بين السلوك الظاهر والعقل الباطن، بين المهارة والمعنى، بين النظام والإبداع.
فالمعلم الحقيقي ليس مروضًا، بل مُلهِم. والتعليم الحقيقي لا يعتمد على العصا والجزرة فقط، بل على إشعال شرارة داخلية لا تنطفئ.
المراجع :
Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. Oxford University Press.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.
Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching. Appleton-Century-Crofts.
Rogers, C. (1969). Freedom to Learn. Charles Merrill.
Slavin, R. E. (2009). Educational psychology: Theory and practice (9th ed.). Pearson Education.